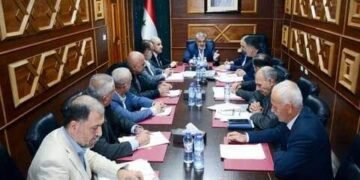الحب هو تلك العلاقة الانسانية التي تجمع بين روحين , وتسمو بهما إلى عالم من المشاعر المتألقة التي تحول الحبيبين إلى صورة نورانية . ولا يظهر الحب في صورة واحدة بل نجده في أكثر من صورة . فهو يتنوع بين البشر أنفسهم ما بين الحب المعروف بين عاشقين إلى حب الوطن والأم والأولاد … الخ
وقد قسم الأدباء العرب الحب إلى قسمين هما الحب الحسي ( الجنسي ) أو ما يقال عنه الحب الصريح , وقد تزعمه امرؤ القيس في الجاهلية وعمر بن أبي ربيعة في العصر الاسلامي . والحب العذري الذي تولد منه قصص الحب الجميلة التي طرزت تاريخنا أمثال قصة المجنون (قيس بن الملوح وليلى) وكثير عزة وجميل ولبنى , وعنترة وعبلة وغيرهم كثر . وقرأنا قصصاً مماثلة لهذه القصص عند الغرب فكانت قصة روميو وجولييت وكذلك قصة الشاعر الفرنسي سيرانو دي برجراك وحبيبته .
وقد تكلم أفلاطون عن الحب فقسمه إلى عشرة أقسام . أولها الهوى وآخرها الهيام , وتابع أفلاطون في دراسته للحب وأقسامه ابن حزم في كتابه ( طوق الحمامة ) وفيه يقول : (( إن الحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنصرها الرفيع )) وهو في ذلك يردد فكرة أفلاطون في المثل فالنفوس الانسانية ترجع في أصل نشأتها إلى نفس عليا واحدة توزعت أجزاؤها في نفوس الناس .
هذا بالنسبة للحب بشكله المطلق أما الحب الذي نحن بصدده فهو حب من نوع آخر . إذا أن صاحبه يتجه إلى ذات عليا هي التي أوجدته فهو يرى فيها المآل والمصير , ويطلب من نفسه الذوبان في حضرة تلك الذات العلية .
وقد عرفت الانسانية بشكل عام هذا النوع من الحب في بداياته على شكل زهد وتأمل كما هو معروف عند جميع الشعوب ( كالهند مثلاً ) .
أما في الحياة العربية فقد عرف العرب الزهد قبل الاسلام على يد أفراد كانوا متحنفين كما هو الأمر عند قس بن ساعدة الايادي مثلاً : فهو يقول :
في الذاهبين الأوليين
ورأيت قومي نحوها
لا يرجع الماضي إليّ
أيقنت أني لا محالة
من القرون لنا بصائر
تمضي الأكابر والأصاغر
لا ولا من الباقين غابر
حيث صار القوم صائر
وفي العصر الاسلامي ظهر الزهد مبكراً في صفوف المسلمين الأوائل كما هو عند أهل الصفة الذين انصرفوا إلى العبادة وأداء الشعائر الدينية تقرباً إلى الله , ثم أخذ هذا الزهد يتحول عند المسلمين إلى التصوف ابتداء من أوسط القرن الثاني الهجري .
وتعتبر هذه المرحلة , مرحلة انتقال من الزهد إلى التصوف . فظهرت نزعة الحب الإلهي عند الزهاد الأوائل من أمثال ابراهيم بن أدهم , والفضل بن عياض وبشر الحافي ورابعة العدوية الملقبة بشهيدة الحب الإلهي .
وخلال هذه الفترة كان الشعر والنثر هما الأداتان اللتان لجأ إليهما هؤلاء الزهاء المتصوفين للتعبير عما يختلج في نفوسهم , حيث كانوا يتناشدون أشعاراً في أدعيتهم وتذكاراتهم في أغراض زهدية وأخلاقية من نظمهم أحياناً أو لشعراء آخرين في أحيان أخرى على سبيل الاستشهاد التأويلي الصوفي . ومن ذلك قول ابراهيم بن الأدهم :
أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر
هي سنة وأنا الضمين بنصفها
مدحي لغيرك لهب نارٍ خفتها
والنار عندي كالسؤال فهل ترى
أنا جائع أنا نائح أنا عابر
فكن الضمين لنصفها يا باري
فأجر عبيدك من دخول النار
أن لا تكلفني دخول النار
هذه الأبيات تظهر زهديتها أكثر مما يظهر فيها الجانب الصوفي . فهي دعائية الأسلوب , وفيها التوسل وذم السؤال , وغير ذلك . وهذا مما يعرف عند الزهاد بشكل أساسي .
ولإبراهيم بيت يقول فيه :
للقمة بجريش الملح آكلها
ألذ من تمرة تحشى بزنبور
فالقناعة بلقمة مع ( جريش الملح ) ألذ عنده وأطيب من تمرة يتبعها لسعة ( زنبور ) من مالٍ حرام .
وعلى الرغم من التقريرية الظاهرة في الأبيات المنسوبة لإبراهيم بن الأدهم والتي تشبه النظم في نسيجها , وبعدها عن النسيج الفني الشعري , ولكن ذلك لا يعني عدم وجود شعر صوفي له بعض المزايا الفنية لبعض متصوفة القرن الثاني كما سنجد عند رابعة العدوية .
فقد ظهرت ملامح شعر التصوف عند رابعة العدوية في أبياتها التي صاغتها تعبيراً عن الحب الإلهي . وفي هذه الأبيات نجد التصور الأولي للتوجه إلى الذات الإلهية , وإظهار الحب بكل معانيه دون أن تصل في معانيها إلى العمق الصوفي كما سنعرفه بعد ذلك .
تقول رابعة مخاطبة الذات الإلهية :
أحبك حبين حب الهوى
فأما الذي هو حب الهوى
وأما الذي أنت أهل له
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي
وحباً لأنك أهل لذاكا
فشغلي بذكرك عمن سواكا
فكشفك لي الحجب حتى أراكا
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا
ففي هذه الأبيات نجد رابعة تنطلق في حبها في اتجاهين . حب خاص , وحب عام بين المخلوق والخالق . النوع الأول هو حب الهوى , أي أنها رأته فأحبته عن مشاهدة اليقين , وأما الحب الثاني الذي هو أهل له , ويعني حب التعظيم والإجلال لوجهه العظيم ذي الجلالة والإكرام . ثم إنها مع ذلك ترى أنها لا تستحق هذا الحب , ولا تستأهل النظر إلى الذات الإلهية في الآخرة لأن حبها لا يوجب الجزاء عليه , وأن أمرها بيد الله عز وجل .
ولرابعة العدوية أبيات ومقطعات تؤكد فيها شدة محبتها للذات الإلهية . تدور حول الدعاء والضراعة والتقرب والتوسل للذات الإلهية كقولها :
يا سروري ومنيتي وعمادي
أنت روح الفؤاد أنت رجائي
أنت لولاك يا حياتي وإني
كم بدت منّة وكم لك عندي
حبك الآن بغيتي ونعيمي
ليس لي عنك ما حييت براح
إن تكن راضياً علي فإني
وأنيسي وعدتي ومرادي
أنت مؤنسي وشوقك زادي
ما تَشتّتُّ في فسيح البلاد
من عطاء ونعمة وأيادي
وجلاء لعين قلبي الصادي
أنت مني ممكن في السواد
يا منى القلب قد بدا إسعادي
وإذا ما تأملنا هذه الأبيات فإننا سنجد الطابع الحسي ظاهرً بكل جلاء ويلوح منها أن الأمر كان وما يزال مختلطاً عليها لأن الخطاب هنا يصح أن يتجه إلى شخص حسي , كما يصح أن يتجه إلى الذات العلية , ومع ذلك فإننا نجد فيها بعض الفنية الشعرية التي تفتقر إليها أبيات ابن الأدهم .
إن ما وصل إلينا من أشعار المتصوفة الأوائل لا تندرج في إطار الشعر الصوفي بشكله الذي عرفناه على يد الحلاج وابن عربي وابن الفارض . بل هو أقرب إلى الزهد منه إلى الاستغراق الصوفي إذ أننا نرى فيه الدعوة إلى القناعة والشكر والرضا ( كما رأينا في أبيات رابعة ) وذم الدنيا وترك الشهوات , والانصراف الكلي إلى التدين والورع والفقر والتوكل والعزلة والوحدة وذكر الحياة والموت والثواب والعقاب مع ظهور بوادر النزعه الصوفيه التي تجلت في محبة الذات الإلهية . ومن أهم ما تميز به الشعر الصوفي أنه اقتصر في نظمه وفهمه على المتصوفة وحدهم حيث كان المتصوفة وحدهم يفهمون رموزه وتأويلاته , ثم يأتي طور ثان هو طور تصاعد نزعة الحب الإلهي وما تولد فيه من مواقف وجدانية وعقلية صوفية كالفناء في الذات الإلهية والوجد والشوق والاتحاد بالذات العليه . وفي هذا الطور استقل الشعر الصوفي وتميز عن شعر الزهد وظهرت نظريات صوفية متطرفة كالاتحاد والحلول والمشاهدة وغير ذلك على يد الحلاج وأبي بكر الشبلي والجنيد البغدادي وسمنون المحب مما جعل هذه الأفكار تصطدم بالأفكار الاسلامية المعتدلة وتخلق خصومات ومشاكل انتهت بمقتل الحلاج وفرار الشبلي وبقية المتصوفة إلى بلاد الشام وفارس وغيرها .
اثر هذه المرحلة ظهر نوع جديد من الشعر الصوفي اتسم بالاعتدال والاقتراب من الطابع السني المعتدل على يد الجنيد عام 267 هـ ثم بدأت هذه الأفكار تأخذ طابع المنهجية ووصفت لها القواعد المعتدلة على يد السراج ( 378 هـ ) في كتابه اللمع وكذلك القشيري ( 465 هـ ) في رسالته المعروفة بالرسالة القشيرية . وغيرهما انتهاء بكتاب أبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين ( 505 هـ ) في الطور الثالث من المرحلة الصوفية شهدت تطوراً شعرياً غزيراً وابداعاً شعرياً جعلهم من كبار شعراء العربية ورواد لمدارس شعرية جديدة لها طابعها الخاص الرمزي ومن أشهرهم محي الدين ابن عربي ( 640 هـ ) وابن الفارض ( 632 هـ ) والقشيري والسراج والسهروردي وغيرهم .
تطور مفهوم الحب الإلهي :
إذا كان الحب عند أوائل الزهاد يعني حب الذات الإلهية وأن يكون الحب لله وحده دون انشغال القلب بحب الدنيا فإن هذا المفهوم في مفهوم المتصوفة الأوائل أصبح يعني التقرب إلى الذات الإلهية بالصبر والرضا , وهما رأس المحبة وقد جسد هذا المفهوم المتصوف عبد الواحد بن زيد المتوفي سنة 241 هـ بروايته للحديث القدسي المروي عن الحسن البصري (( إذا كان الغالب على عبدي انشغاله بي جعلت نعيمه ولذته في ذكري , فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكري عشقني وعشقته , فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه ( تاريخ التصوف الاسلامي ) ونرى في هذا الحديث تحول تام لمعنى الحب عند المتصوفة إلى معنى العشق . على اعتبار أن الحب يضعف بالبعد بين المحبين , وهذا الحب ثابت وأزلي , وممن دعا إلى هذا النوع من الحب ( العشق ) شفيق البلخي ويحيى الواسطي وإبراهيم بن أدهم الذي دعا إلى دوام حب الله والانشغال به دون سواه . لأن المحبين في مفهومه هم المشتاقون . وقد أكد الباحثون في التصوف الاسلامي رداً على الاتهامات التي وجهت إليه بأن جذوره ترجع إلى المسيحية أو لديانات هندية ،و هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى فكرة الحب بين الله وعباده كقوله تعالى ( إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ) ( البقرة 16 ) .
وقد اختلف أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الآية مع علماء الصوفية لأنهم اعتبروا أن المقصود هنا حب الطاعة والعبادة والتعظيم بينما كان مفهوم الآية عند أهل التصوف هو المحبة والعشق والغناء بالمحبوب والشوق إلى لقائه . وترجمها الصوفيون بأشعار تعبر عن مفهومهم لذلك عبر شعر رابعة العدوية كما ذكرنا وغيرها من الشخصيات الصوفية .
ولقد تبلور مفهوم المحبة في القرن الثالث الهجري على يد الشبلي والحلاج . فقد لاحظ الحلاج أن الناس في عبادتهم لله تعالى خوفاً و طمعاً فقط يهدرون أسمى رابطة يمكن أن تجمع الخالق مع مخلوقه وهي الحب . و إذا كان الله قد خلق الخلق ليعبدوه فإن هذا يعني أنه خلقهم ليعشقوه ، و هذا هو السبب في أنه خلق آدم على صورته ( كما ذكر كامل الشبيبي و محمود التويجري في كتابه ( خلق آدم على صورة الرحمن )) و لكني أرى أن هذا التفسير غير صحيح و أن ما قصده الحلاج هو أن خلق آدم على صورته الجميلة لكي يكون تجليا للخلق الجميل لله تعالى و هو صفة من صفات الله .
و قد تناول الحلاج في شعره عدداً من الموضوعات التي كانت في مجملها تصب في التصوف والحب الإلهي وهذه الموضوعات هي التصوف العملي والحب الإلهي والمعرفة , والاتحاد وطبيعته والغناء وشطحاته والنور المحمدي ووحدة الأديان . وهي كما نرى تجمع العناصر الأساسية التي تتكون منها آراء الحلاج ومذهبه في التصوف .
ففي التصوف العملي لم يخرج الحلاج عن دعوات الصوفيين في ذم الدنيا والزهد فيها يقول في ذلك :
دنيا تخادعني كأني
حظر الإله حرامها
مَدّت إلى يمينها
ورأيتها محتاجة
لست أعرف حالها
وأنا اجتنبت حلالها
فرددتها وشمالها
حتى أخاف ملالها
فهو يرى أن الدنيا حسناء تحاول اغواءه ولكنه يبتعد عنها لأنه لا يرغب الاتصال بها بل هو يتجنب كل شيء فيها من حلال وحرام .
وهو يتألق في تجلياته الصوفية ومجاهداته التي يظهر أثرها في شعره الذي يظهر سلساً واضح المعاني منسق الأفكار .
لي حبيب أزوره في الخلوات
ما تراني أصغي إليه بسمع
كلماتٍ من غير شكل ولا نط
فكأني مخاطب كنتُ إيا
حاضر غائب قريب بعيد
هو أدنى من الضمير إلى الوهـ
حاضر غائب عن اللحظات
كي أعي ما يقول من كلمات
قٍ ولا مثل نغمة الأصوات
ه على خاطري بذاتي الذاتي
وهو لم تحوه رسوم الصفات
م وأخض من لائح الخطرات
هذه الأبيات تشعرنا بأن الحلاج يرتفع في مقام الصوفية من التأمل والعبادة , والتفكر في الثواب والعقاب إلى مقامات أعلى يقصد فيها قرب المحبوب ( الله ) ولذلك كان الذكر عنده ( وعند الصوفية بشكل عام ) في خلواته يتجاوز الصلاة وحتى قراءة القرآن لأنه ( كما يقولون ) يعين على تقريب حالة الوجد واستحضارها . والوجد كما نعرف من أهم الحالات في حياة الصوفي . فهو الباب الذي يدخله إلى العالم الرحب الواسع , عالم الجذب ويؤكد الحلاج على أن أسرار التصوف يجب أن تبقى بعيدة عن العامة وأهل الظاهر لأن هؤلاء لن يستطيعوا فهمها واستيعابها , وأن أي كشف لهذه الأسرار هو إخلال لآداب الطريق الصوفي يستحق صاحبه العقاب . يقول في ذلك :
مَنْ سارروه فأبدى كلَّ ما ستروا
إذا النفوس أذاعت سِرَّما عَلِمَتْ
من لم يصن سِرَّ مولاه وسيده
وعاقبوه على ما كان من زللٍ
وجانبوه فلم يصلح لقربهم
ولم يراع اتصالاً كان غشاشا
فكل ما حملت من عقلها حاشا
لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا
وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا
لماّ رأوه على الأسرار نباشا
أما في الحب الإلهي فإن الحلاج يملك ثروة شعرية كبيرة , وفيها تبدو شخصية الحلاج رقيقة متفانية بحب الله وهو يلجأ فيها إلى الوضوح , فقصائده مكشوفة تحتمل معنيين الحب الصريح ( الظاهر ) والمعنى الصوفي ( الباطن ) ويمكن أن نقسم أسلوب الحلاج الشعري في غزله الإلهي إلى قسمين . أولهما الغزل الذي لم يستخدم فيه الرمز , ويحتمل كما ذكرنا المعنيين الإلهي والبشري , والقسم الثاني الذي لا يحتمل معناه إلا الغزل الإلهي لأنه يستخدم فيه الرمز الذي يقترن بصفات الذات الإلهية .
فمن النوع الأول قوله في إخلاص المحب لمحبوبه :
سكنتَ قلبي وفيه منكَ أسرار
ما فيه غيرك من سر علمت به
وليلة الهجر إن طالت وإن قَصُرَت
إني لراضِ بما يرضيك من تلفي
فلتهنك الدار بل فليهنك الجار
فانظر بعينك هل في الدار ديّارُ
فمؤنسي أملٌ فيه وتذكار
يا قاتلي وَلِماَ تختار أختار
إن هذه الأبيات كما نرى تحتمل المعنى الظاهري المكشوف وهو بث الشكوى للمحبوب الانساني والكشف له عما يعانيه من حب يتغلغل في حنايا نفسه تجاهه . وكذلك يمكن لنا أن نرى أنها تتوجه إلى الله حبيباً ينفرد بحبه ولا يرضى إلاه محبوباً .
ومن أسماء النوع الثاني من هذه القصائد التي تتجه في غزلها اتجاهاً واحداً هو الغزل الإلهي الذي يكون فيه الكلام قاصراً على الحب الإلهي فقط والذي يدخل في صميم الاستغراق الروحي الذي يتجلى في الأبيات صريحاً واضحاً كهذه الأبيات :
لبيكَ لبيكَ يا سري ونجواي
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل
يا عينَ عينَ وجودي يا مدى هممي
يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري
يا كل كلي وكل الكل ملتبس
لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي
ناديتُ إياك أم ناديتَ إيائي
يا منطقي وعبارتي وإيمائي
يا جملتي وتباعيضي وأجزائي
وكل كلك ملبوس بمعنائي
فالحلاج في هذه الأبيات يخاطب محبوبه ويصفه بأنه سره ومعناه وأن في دعائه لمحبوبه دعاء محبوبه إياه , إنهما متحدان فأصبح المحب هو الحبيب هو وجوده ومنطقة وسمعه وبصره , لقد تناول هذا الاتحاد كل ذرة من ذرات وجود الحب فلم يعد بينهما فرق . ( وهذا النوع من الغزل ليس معروفاً إلا عند المتصوفه) لأنه تغزل في الحب الروحاني الصوفي الذي يبتعد عن معاني الغزل الانساني بكل مكوناته وأشكاله . وله اتجاه ثالث في شعره وهو الشعر الذي يعبر فيه عن الاتحاد والفناء في حب الله . هذا الفناء الموهوب المزروع في داخله كنبتةٍ راح يسقيها من فيض حبه وتعبده ويغلب عليه السكر والدهش , إنه الشعور بالاتحاد الكامل بين المحب والمحبوب ولا يتم إلا في حالة جذبيةٍ يصاحبها غيبة عن الصور والأكوان , فإذا ما أفاق الغائب عن غيبته رجع إلى مقام التفرقة , وقد عبر الحلاج عن مقام الجمع بقوله :
رأيت ربي بعين قلبي
فقلت من أنت قال أنت
وهذا الاتحاد الذي يحصل بين الحلاج وربه هو اتحاد صوفي و يعتمد النظر العقلي لأنه حالة ذوقية تسيطر على المتصوف فيشعر بالوحدة مع الله ويرى الجمع شيئاً واحداً ومن المعروف أن الحلاج دخل في كثير من قصائده في مرحلة ( الشطح ) كما يقول المتصوفه ولذلك نطق بقوله : ( أنا الحق ) وكرر هذا القول في شعره :
أنا من أهوى ومن أهوى أنا
فإذا أبصرتني أبصرته
نحن روحان حللنا بدنا
وإذا أبصرته أبصرتنا
وهو صاحب مذهب الحلول الذي يرى فيه الاندماج الكامل بينه وبين الذات الإلهية . وقد نسب للحلاج تأثره بالفكر المسيحي .
ويبدو أن مقتل الحلاج نتيجة هذا التوجه على يد الخلافة العباسية قد خفف من غلواء هذا التطرف في الفكر الصوفي , فظهر بعده طور آخر للشعر الصوفي كان دوره التوفيق بين الأفكار الصوفية والشريعة الاسلامية وأحكام القرآن والسنة النبوية على يد أبي نصر السراج صاحب كتاب ( اللمع ) والقشيري صاحب كتاب الرسالة القشيرية ) وغيرهم . وبدأنا نجد تطوراً إيجابياً هادئاً لفكرة الحب الإلهي وربطه بالطاعة والعبادة وأداء الفرائض , وعدم رفع التكليف كامتياز خاص لمن يصل إلى درجة الولاية كما كان يحصل سابقاً . وأصبح أداء الأركان هو أساس الإيمان . وفي هذه المرحلة أرسى الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين هذه المفاهيم . إلا أن الظواهر الصوفية التي كانت منتشرة في عهد الحلاج بقيت قائمة ولكن بشكل أخف فكانوا يرون أن أهل المحبة الذين اصطفاهم الله اصطفاء هم القادرون على الوفاء لخالقهم ولذلك كانوا إذا رأوا وجهاً جميلاً وسمعوا صوتاً حسناً رقيقاً أو شهدوا منظراً رائعاً أخذوا به ورأوا فيه إمارة على الجمال الإلهي المطلق ورمزاً له .
وكانوا يرمزون بأسماء ليلى ولبنى وغيرهما من عرائس الشعر الغزلي للتعبير عن الحب الإلهي , وكذلك ألفاظ أخرى مثل الحي والديار والنار والوجد والبعد والقرب .
وإذا ما انتقلنا إلى القرن السابع الهجري فإننا نجد علمين من أعلام الصوفية قد جسدا هذه الصور الروحية الجمالية في العمق الصوفي , وتجلى على أيديهما شعر الحب الصوفي الإلهي والشعر والخمر الالهي هما محي الدين بن عربي و ابن الفارض حتى ليصح أن نسمي هذا القرن عصر ابن عربي وابن الفارض .
ومن غزل ابن عربي في هذا الاتجاه قوله :
يا حسنها من طفلة غرّبها
لؤلؤة مكنونة في صرف
لؤلؤة غواصها الفكر فما
يحسبها ناظرها ظبي نقا
تضيء للطارق مثل السرج
من شعر مثل سواد النسج
تنفك في أغوار تلك اللجج
من جيدها وحسن ذاك الغنج
هذه الأبيات تجسد لنا نظرة ابن عربي للانطلاق في بحر الحب الصوفي وكيف أنه استخدم المفردات الحسية كما رأينا في التعبير عن وجِده واستغراقه في محبة الجمال الذي يوصله إلى عتبة الهيام والاستغراق في الحضرة الإلهية .
ويسمي ابن عربي ديوانه ترجمان الأشواق , وهو يرى أن العارفين لا يستطيعون أن ينقلوا مشاعرهم جملة إلى غيرهم من الناس , فكل الذي يستطيعونه أن يرمزوا إليها .
فوجنات الحبيب الموردة تمثل عنده ذات الله منكشفة في صفاته , وغدائرها الليلية تصور الواحد محجوباً بالكثرة .
وابن عربي يعلن على الملأ أن ليس دين أرفع من دين الحب والشوق إلى الله . فالحب خلاصة النحل جميعاً , والصوفي الصادق يرحب بدين الحب على أي صورة تبتدئ بقول :
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة
وبيت أوثان وكعبة طائف
أدين بدين الحب أنى تَوَجَّهَتْ
لنا أسوة في نشر هند وأختها
فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وألواح توراة ومصحف قرآن
ركائبه فالحب ديني وإيماني
وقيس وليلى ثم ميّ وغيلان
ويشرح ابن عربي البيت الأخير بقوله : الحب من حيث هو حب لنا ولهم حقيقة واحدة غير أن المحبين مختلفون لكونهم تعشقوا بكون وأنا أعشق بعين والشروط والأسباب واحدة وأما عمر بن الفارض الملقب بـ ( أمام العاشقين ) فقد نسخ آية العشق ممن قبله حتى أصبح من حقه أن ينادي كل من يأتي بعده أن يقتدي به ولا تزال قصائده الصوفية تحدث دويها في المحافل الصوفية والمنتديات الأدبية . وقد ترجمت تائيته الكبرى إلى أكثر من لغة .
كان ابن الفارض شديد التأثر بالجمال حتى بجمال الجمادات , وكان يسحره جمال الألحان , فإذا سمع انشاداً جميلاً استخفه الطرب فتواجد ورقص ولو على مشهد من الناس ( أمراء الشعر العربي في العصر العباسي – أنيس المقدسي ) ولابن الفارض شعر كثير ومطولات شعرية يلخص فيها أحوال المحبين والعشاق وشهداء الغرام الإلهي منها ميميته المشهورة . وجاء فيها :
ولو جليت سراً على أكمه غدا
ولو أن ركباً يمموا قرب أرضها تقدم كل الكائنات حديثها
بصيراً ومن راووقها يسمع الصم
وفي الركب ملسوع لما ضره السم
قديماً ولا شكل هناك ولا رسم
وكذلك نجد تائيته الكبرى التي شغلت الناس زمناً طويلاً فهي تعتبر نشيد الوجد الروحي , وفيها نشعر بذلك الحب الأسنى الذي يملك على الناظم حواسه , فيسكره وينقله من عالم المادة إلى عالم الروح ومطلعها :
سقتني حميا الحب راحة مقلتي
وكأسي محيا من على الحسن جَلَّتِ
إن الحب الحقيقي عند ابن الفارض هو الذي ينتهي بتلاشي إرادة المحب واتحاده في حقيقة المحبوب كما تتلاشى إرادة طفل صغير فيرمي بنفسه في أحضان أمه وأبيه دون مقاومة .
خصائص الشعر الصوفي :
يستطيع أي باحث في الشعر الصوفي من خلال استقرائه للنصوص الشعرية الصوفية أن يخرج بطائفة من الخصائص التي يتميز بها هذا الشعر ولا سيما عند كبار الشعراء أمثال الحلاج والشبلي وابن عربي وابن الفارض وغيرهم من شعراء التصوف الاسلامي :
ومن أهم هذه الخصائص :
1- التباين الدلالي : أي التفريق بين علم الظاهر وعلم الباطن .
ويقصد بعلم الظاهر أساساً علم الشريعة لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرة (العبادات –الأحكام الشرعية) أما علم الباطن فيتعلق بالأعمال الباطنة كأعمال القلوب ( المقامات الأحوال ) كالتصديق والايمان واليقين والاخلاص والتوكل والمعرفة والمحبة والرضى …. الخ .
ولكل الأسماء التي ذكرناها وغيرها معنى محدد في معاجم اللغة إلا أنها تفقد دلالاتها المعجمية في التفكير الصوفي فالصبر مثلاً يعني عندهم . الصبر عن المكروه والصبر عن الصبر , وله مراتب ومدارج . وهكذا نجد هذا الترتيب في كل المفردات في الفكر الصوفي .
ولنأخذ مفهوم الحب عندهم كمثل ينطبق على كل المفردات الأخرى .
فالحب الذي هو ميل القلب والعواطف إلى المحبوب وحب العبد لله شرعاً ( أي طاعة ) أوامره واجتناب محارمه ) وإيثار ذلك على كل شيء وقد قال رسول الله (ص) من علامة المؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما .
وهذا الحب بمعناه الشرعي هو حب عقلي لا عاطفي غير أن هذا المفهوم الشرعي للمحبة تحول من معناه العقلي إلى معان أخرى , فأصبحت لفظة حب الله تعالى تطلق على العلاقة بين العبد والخالق بحيث لا تقوم على الخوف من عقاب أو رغبة في ثواب بل يقصد بها مطالعة وجهه الكريم والاستمتاع بجماله .
ومثلما خرجت لفظة المحبة عن مدلولها المعجمي إلى مفاهيم أخرى عند الصوفية كذلك خرجت بقية الأسماء التي صارت عندهم مقامات وأحوالاً , فالوجد مثلاً عند المحبين تعني شدة الشوق وعدم الصبر عن المحبوب أصبحت عند الصوفية تعني حالة من الهستيريا واصدار أصوات والرقص حتى الإغماء عند سماعهم صوتاً جميلاً أو منظراً جميلاً أو وجهاً صبوحاً . وهكذا بقية المفردات .
2- فكرة القطب والجوانب الستة : يقول د. نجم مجيد علي في بحثه عن أشعار الحب الإلهي : يعتقد الصوفية أن الله تعالى مصدر كل شيء وخالق كل شيء , ويشاركهم في هذا عامة المسلمين . إلا أنهم يعتقدون أن كل الأشياء تدور حول الذات الإلهية كما تدور الأجرام السماوية حول الشمس , وكما يطوف زوار الكعبة حول البيت من الاتجاهات الأربعة , وأضافوا إليها اثنين ( الفوق والنحت ) لتصبح ستة وقد ترجموا ذلك في أشعارهم كقول الحلاج :
العشق من أزل الآزال من قدمٍ
فيه به منه يبدو فيه إبداء
ومن هنا جاءت فكرة القطب الذي هو مفهوم المتصوفة الذي تدور حوله كل الأشياء فهو المتطرف في اقضية الوجود وأقداره وكأنه ينوب عن الله في ملكوته .
ولذلك كانوا يلتفون حوله كما تلتف الأجرام السماوية حول الشمس وكما يطوف زوار الكعبة حول البيت .
ونرى في محاولتهم للدلالة على القطب يستخدمون حروف الجر من ضمائر الغيبة في أشعارهم ويكررونها كثيراً حتى تفقدهم هذه الحروف والضمائر رونق الشعر وجماله , ويصبح أقرب للركالة منه إلى الشعر الجميل . كما في قول الحلاج :
يا كل كلي وكل الكل ملتبس
وكل كلك ملبوس بمعناني
وقد دفع تزاحم الأفكار الصوفية في أذهان المتصوفة إلى تكرار كلمات وجمل أخلت بالموسيقى الشعرية مثل قول الحلاج :
لا نوار نور النور في الخلق أنوار
وللسر في سر المسرين أسرار
3- الخمر الإلهي والسكر الإلهي : وفي هذا الجانب نجد أن شعر الصوفية يحوي ميزة أخرى نجدها في شعرهم ظهرت منذ شعراء القرن السابع الهجري .
والسكر الإلهي حالة من الدهش الهجائي يعتري المحب فيذهب عن كل حس غير حضور الحبيب , ويغمر نفسه بنشاط دفاق يوقد فيه الوله والهيجان , وما كان ذلك ليحدث لولا امتلاء قلب المحب لله تعالى فالسكر بخمرة المحبة هي منتهى العبادة عند هؤلاء . يقول الشبلي :
إن المحبة للرحمن تسكرني
وهل رأيت محباً غير سكران
والشراب الصوفي ليس خمراً تدير الرأس وتثقل النفس بل أنها تنعش الوجدان وتجلو عين البصيرة , وتفتح أمام القلب أرحب الآفاق .
يقول ابن الفارض :
شربنا على ذكر الحبيب مدامة
سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم
ألا تجد كيف أن هذا السكر الذي أصاب ابن الفارض هو سكر محبة وتفان في حضرة الذات الإلهية وجدت في نفس المتصوف قبل أن يعرف الانسان خمرة السكر البشرية أي الكرمة .
4- عرائس الشعر الصوفي : يجد المتلقي في شعر المتصوفه الكبار امثال ابن عربي وابن الفارض والرفاعي والكيلاني وغيرهم أسماء انثوية مثل ليلى وسعاد وزينب ولبنى وغيرهن كثر , كما يفعل شعراء الغزل أمثال قيس ابن الملوح وجميل بن معمر وغيرهما ممن عرفوا بالحب والعشق لمحبوباتهم . ولكن استعمال المتصوفه لتلك الأسماء ليست إلا رمزاً أو عرائس لشعرهم تعبيراً عن الحب الإلهي .
فليلى لم تعد ليلى العامرية وديارها ليست مضارب بني عامر وإنما هي رمز لحب اسمى هو حب الذات الإلهية كما يرى ابن عربي مثلاً إذ أن دين الحب هو أرفع الأديان في نظره والشوق إلى الله خلاصته الحب في نظره أيضاً . فالصوفي الصادق يرحب بدين الحب على أي صورة تبدي . يقول :
أدين بدين الحب أنى توجهت
لنا أسوة من نشر هند وأختها
ركائبه فالحب ديني وإيماني
وقيس وليلى ثم مي وغيلان
ولما كان الشاعر العاشق يرحل رحلة شاقة لرؤية من يحبها بعد أن اقترنت بغيره متجشماً الصعاب ومعرضاً نفسه للمخاطر . كذلك يفعل الشاعر الصوفي في رحلته نحو المحبوب ( الله ) فليلى رمز الحب الإلهي والرحلة بحث متواصل عنها وبين ضباب الدموع والبهاء الإلهي يظهر الوجه الأقدس لهؤلاء المحبين وما الوجد والشوق والوصل والهجر … الخ إلا اختبارات نفس شديدة الاحساس في سعيها نحو مصدر الجمال الأسمى الذي يبحث عنه الشاعر الصوفي . كما فعل ابن الفارض في كثبان طيء وبذات الشيح يقول :
سائق الأظعان يطوي البيد طي
وبذات الشيح عني إن مرر
وتلطف واجر ذكري عندهم
منعماً عرج على كثبان طي
ت بحيّ من عريب الجزع حي
علهم أن ينظروا عطفاً إلي
وقوله :
هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل
فمن لم يمت في حبه لم يعش به
فما اختاره مضنى به وله عقلُ
ودون اجتناء النحل ما جنت النحلُ
وأخيراً نلفت النظر إلى أن من يتصفح الشعر الصوفي بشكل عام يجد في معظمه ضعفاً واضحاً في ألفاظهم وركاكة في تراكيبهم اللغوية وذلك لأن الشعر الصوفي هو شعر ديني يهتم بشكل أساسي بتأدية المعنى دون الاهتمام باللفظ , ويبدو أن معظم أدباء الصوفية كانوا يفتقرون إلى ثقافة لغوية وأدبية وفنية تمكنهم من صياغة التعبير الشعري صياغة فنية بالإضافة إلى أن المتصوفة كانوا منشغلين عن ذلك بتأملاتهم الروحية التي تبعدهم عن الاستغراق في فنية الشعر وصياغته الأدبية .
إلا أن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بأن بعض شعراء الصوفية أبدعوا في جزء من قصائدهم فأعطونا صوراً جميلة كما في شعر ابن الفارض وابن عربي والحلاج ولكن ذلك لم يدم طويلاً فقد تدهور الشعر الصوفي بعد القرن السابع الهجري وأصبح أراجيز تخدم فكر الصوفية دون الالتفات إلى فنية التعبير .
د عبد الحميد ديوان
د. عبد الحميد ديوان · · من كتابي الإعجاز البلاغي للكلمة:في الأدب الصوفي
رفعت شميس - تصميم مواقع الانترنت - سورية 0994997088
رفعت شميس - تصميم مواقع الانترنت - سورية 0994997088