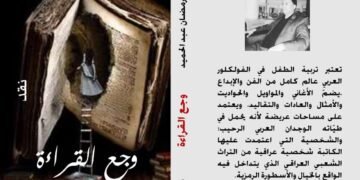مبادئ النقد ونظرية الأدب / السنة الثانية
المحاضرة السادسة
طبيعة الأدب, ووظيفـتة
طبيعة الأدب :
ذكرنا في المحاضرات الأولى أنّ نظرية الأدب تدرس الظاهرة الأدبية , وتُعَدّ طبيعة الأدب من الموضوعات الأولى التي تتحدّث عنها النظريات الأدبية, عندما تحدد نقاط الارتباط بين الأدب وغيره من النشاطات الإنسانية الأخرى , ويقسم دارسو الأدب هذه الارتباطات على الشكل التالي :
1- الارتباط بين طبيعة الأدب والعمل :
يُنظر إلى الأدب على أنه أحد النشاطات الإنسانيّة العمليّة , أحد سمات الشخصيّة الإنسانيّة . ويجسّد الإنسان ,أو يعكس في عمله هذا العلاقة بينه وبين العالم , أي, إن الأدب جزء من البنية الفوقيّة التي تشمل كل النشاطات الإنسانية الفكرية, من فلسفة, وعلم, وسياسة, وقانون, ودين, وعادات وتقاليد, وكل ما يعكس الصراعات الاقتصاديّة, وتعامل هذا الإنسان مع الواقع المادي أو ما يسمى البنية التحتيّة. وكل النشاطات الفكريّة الإنسانيّة التي ذكرت إنما يلجأ إليها, أو يبدعها الإنسان وهو يسعى لتحقيق الانسجام بينه وبين الحياة, بينه وبين الطبيعة .
بعبارة أخرى : إن طبيعة الأدب ترتبط بالعمل, والعمل هو نوع من الإبداع نما فيه الحس الجمالي وتطور معه ليصبح حاجة روحية إنسانية تجعل الجميل يتضمن النافع ولا يتناقض معه, وهو إضافة إلى ذلك مجال يحقق الإنسان من خلاله قدرته على الخلق وطاقته الإبداعية .
2- الارتباط بين طبيعة الأدب وتطور الوعي والمعرفة :
الأدب أحد أشكال الفن , أحد أشكال الوعي , إذ إن العلاقة بين مختلف جوانب الأدب أي بين المعرفي و الإبداعي , بين النشاط العفوي والنشاط الواعي , بين الحسي والعقلي إنما تعكس على نحو دقيق ومباشر نمط العلاقة بين الفرد والمجتمع في كل عصر , كما إنها ترتبط بهذا النمط أوثق ارتباط , حيث إن إدراك العالم ومعرفته واستيعابه استيعاباً جمالياً ترافق مع أولى لحظات العمل وتشكل الوعي. ومن هنا نرى أنّ أي تطور في الوعي لا بدّ أن ينعكس تطوراً في الإبداع الأدبي.
3- الارتباط بين طبيعة الأدب والمجتمع :
إن ارتباط الأدب بالعمل , وارتباطه بتطور الوعي والمعرفة يؤديان إلى ارتباط طبيعة الأدب بالمجتمع . وقد عرّف أوستين وارن ورينيه ويليك الأدب بأنه مؤسسة اجتماعية أداته اللغة , وهي من خلق المجتمع . وإذا كان الأدب يمثل الحياة, فإن الحياة هي عملياً حقيقة اجتماعية واقعية . إن كل أدب يتحرك في وسط لغوي معين , وتميز الأدب من غيره أي تحديد طبيعته إنما يتم من خلال المادة التي يتشكل منها أي من خلال اللغة , ولغة الأدب كما عرفنا تتميز من لغة الحياة اليومية أو لغة العلم بأنها تنظم وتشد معطيات اللغة لتجعل منها أداة تضعنا في حالة من الوعي والمتعة الخاصين , ولتدفع بها لتقوم بمهمتها الأساس, وهي التبليغ وتحقيق التواصل , ولكن هذا لا يعني أن يتحول الأدب إلى صيغة لغوية. إن الكلمة تبقى الأداة الأرحب صدراً والأكثر طواعية في استيعاب ماهيات الوقائع, وتفاصيلها, فهي أكثر حضوراً وفعالية من الصوت في الموسيقا, واللون في الرسم, أو الشكل في النحت .
مع ظهور الكلمة يولد الزمن في الأدب, أي يتم التمييز بين الماضي والحاضر والمستقبل , ومن خلالها تتحدد العلاقة بين الماضي والحاضر, و الحاضر والمستقبل, فتظهر حركة الفكر. والكلمة هي التي تسبك هذه العلاقة بين الزمنين. إنّ الأدبَ نوعٌ راقٍ من أنواع العمل الاجتماعي , ومادة البناء فيه هي الكلمة أي الشكل المتميز للوعي . هذا يعني أنّ الأدب إبداع كلامي, يقوم به الإنسان انطلاقاً من فعل الوعي , وعلى هذا يتحدد مكان الأدب الوسطي, بين المعرفة النظرية والنشاط العملي المادي حيث تظهر المعرفة. والكلمة ” اللغة ” هي التي تحقق للأدب مهمته التبليغية (إيصال الرسالة) والتواصلية والمعرفية , وتجعله خطاباً, أو خطاباً موجهاً نحو الحقيقة والأخلاق .
الناقد تودروف يقول : ” إن الأدب متصل بالوجود الإنساني كله ..ولن يكون الأدب شيئاً إذا لم يتح لنا أن نفهم الحياة بصورة أفضل .”. أما الفيلسوف سارتر فيرى أن ” الأدب هو كشف للإنسان والعالم .”. في حين يشير كونديرا إلى أن الأدب محاولة لكشف ” جانب مجهول من الوجود الإنساني ويشير إلى أن الأدب يبحث دائماً عن الحقيقة فهو لا يتوقف أبداً عن البحث عنها , وهو ليس بحثاً عن الحقيقة وحسب ولكنه هذه الحقيقة أيضاً .
4- الارتباط بين طبيعة الأدب وقدرة الإنسان :
ترتبط طبيعة الأدب بقدرات الإنسان اللامتناهية على خلق الأشياء الواقعية والمتخيلة , وعلى التعامل مع أية مادة, أو أي حدث, أو فكرة, أو معاناة , وعلى تنظيم هذه الأشياء, وترتيبها, وتنسيقها وفقاً للقيم الجمالية بحيث يخلق بينها انسجاماً , وهذا يعني أن الأدب هو صياغة لموقف إنساني غايته وهدفه الإنسان , فهو قيمة إنسانية اجتماعية لا تقف عند حد التعبير عن الحياة الإنسانية بل تضيف إلى الحياة وتنميها في آن .
إذن إن حقل الأدب, ومجاله, يشتمل على كل ما يقوم به الإنسان من نشاط عملي , ومادة الأدب هي اللغة باعتبارها مؤسسة اجتماعية , وغاية الأدب الإنسان وتكوينه الروحي والجمالي
مكونات الأدب:
أولاً : المكوّن المرجعي
ويقصد به العالم الموضوعي الذي يتناوله الأدب بمعزل عن الصياغة الجمالية لهذا لعالم الموضوعي, فالأدب مرتبط بشروط الحياة الفعلية ومعطياتها, ومع النشاطات الإنسانية المنبثقة عنها, وهذا كله يؤكد انطلاق الأدب من الواقع الموضوعي , ولكن هذا لا يعني أن هذا الواقع يفرض علينا ذاته بعيداً عن المشاعر أو الأحاسيس أو النظرة الجمالية. إن الأدب يقدم هذا الواقع مصاغاً صياغة جمالية. ويمكن أن نلحظ ارتباط الأدب بالحياة, أو بالوقائع والأحداث, والبيئة في أدبنا العربي, وتحديداً في شعرنا الجاهلي القديم, وكذلك في الشعر الإسلامي, حيث رصد الشعر سطوة الطبيعة, وقسوتها, وحيواناتها وتحدياتها , ويصور كذلك كيف فرض هذا الواقع وعياً روحياً محدداً, تجلى في قيم محددة, وأخلاق تناسب الحياة , وحتى الإيقاع الحاد للشعر , والمكون البنائي للقصيدة, إنما يعكس وعي أصحابه . بعبارة أخرى إن القصيدة الجاهلية تجسد الحياة الجاهلية بكل ما فيها .
إن وجود هذه المرجعية الموضوعية لا يقف عند حد المرئي والمكتشف بواسطة العلم والفن , بل يتضمن أيضاً مسارات الحركة والتطور حيث تتوالد أشكال عديدة للواقع, وظهور الأشكال الجديدة هو الذي يشكل مرجعية للأدب وتستوجب استمرار الإبداع وتطوره. ” إن العلاقة بين الأدب والمرجع هي عملياً العلاقة بين الذات والموضوع “. ولما كان الأدب يعكس تطور الحياة المستمر فإنه لا بد أن يعكس حياة الفكر وتطوره أيضاً. بعبارة أخرى يتجلى في الأدب الارتباط بين المكونين المكون المرجعي الموضوعي والمكون الفكري. فالأدب لا يستطيع أن ينفصل عن الواقع المحيط به وعن حياة المجتمع , ولا يستطيع كذلك أن يبتعد عن القيم الموجودة في المجتمع وعن الوعي الاجتماعي والفكري والسياسي وهو بذلك يرصد أشكال الصراع والنضال بين الحياة وأبنائها .
ثانياً : المكوّن الفكري
إن المكون الفكري في طبيعة الأدب هو الفكرة التي يصوغ فيها الأديب تجاربه وعلاقاته بالمكون الموضوعي ” المرجعي ” وبالعالم المحيط به وكل ما يشغله ويدفعه إلى الكتابة ويجب أن نعي أن الفكرة قبل أن تدخل في التفاعل الأدبي شيء وبعد أن تدخله وتتحقق فنياً شيء آخر . بعبارة أخرى : إن التعبير الإبداعي الأدبي عن الفكرة يختلف عن التعبير المنطقي عنها فهي في الأدب تعبير فني وفي الحياة تعبير اجتماعي . وإذا ما تحول الأدب إلى منظومة من الأفكار المجسدة فقط يفقد أهميته المعرفية والاجتماعية والفنية لأن الوظائف المعرفية والاجتماعية والفنية مترابطة في الأدب . وقد أشار الناقد الأدبي شيدرين إلى هذا الترابط في رده على الذين ينفون وجود مكون فكري في الإبداع قائلاً : ” إن الفكر والفن ليسا عدوين على الإطلاق , فالفكر هو العامل الرئيس والحتمي في جميع الأعمال الإنسانية , أما الإبداع فهو تجسيد الفكر في صور حية .” .وإنكار المكون الفكري أو المحتوى يعني أن يخرج الأدب إلى حقل الوصف الطبيعي لأمور لا قيمة لها ولا غاية بدلاً من أن يكون رؤية واعية للعالم . وغالباً ما تلهم الأفكار السامية الكبيرة الأديب وتحثّه على التقصي والبحث الإبداعي فتفتح له الطريق أمام الإبداع الحقيقي . صحيح أنه ليس كل الأدباء مفكرين كبار, ولكن هذا لا يعني أنه ( الأديب ) لا يمتلك رؤية شمولية, وفهماً واضحاً للحياة. إنه يرى أكثر مما نرى, ويسمع أكثر مما نسمع.
ثالثاً : المكوّن الجمالي
وهو المكون الثالث الذي تتشكل منه طبيعة الأدب والذي يثير فينا بفضل خصائص الصياغة الأدبية إحساسات جمالية أو انفعالات شعورية , أي, إن المكون الجمالي يتجلى في التشكيل الفني , في بنية العمل الأدبي وصورته وخصائصه اللغوية وطبيعة تشكله . إن الخصائص الفنية تقوم على قيم جمالية مميزة للأدب , ولا بد لهذا الأدب من أن يثير فينا شعوراً محدداً , أي إنه يتضمن شحنة شعورية إضافة إلى ما يحمله من فكر يتكفل بنقله وإيصاله .
إن ظواهر الواقع هي التي تكوّن الجانب الجمالي حيث يتكون فيها الجوهر الجمالي: الرائع, والجميل, والقبيح . أي, إن متطلبات الواقع والعصر والمجتمع الجمالية هي التي يجري بالتفاعل معها تطور الفن في مرحلة محددة , وهي التي تنعكس بوضوح في خصائص العمل الإبداعي وتظهر فيه بشكلها الأمثل .
أخيراً يجب أن نعلم أن هذه المكونات الثلاثة : المكون المرجعي , والمكون الفكري , والمكون الجمالي مرتبطة فيما بينها أوثق ارتباط , وهي مجتمعة تشكل طبيعة الأدب , وإذا غاب أحدها كفّ النصّ عن أن يكون أدباً, وتحول إلى نوع آخر من الكتابة العلمية أو الصحفية .
وظيفة الأدب
عرّفنا سابقاً الأدب بأنه شكل من أشكال التواصل اللغوي بين البشر , ولكنه تواصل خاص أكثر سمواً ورقياً من كلّ أشكال التواصل الأخرى , لأنّ الأديب يستطيع عبر ما يبدعه التعبير عن نفسه , وإيصال ما يريد إيصاله إلى الآخرين “المتلقي “, أو المرسل إليهم, إيصالاً حيّاً خالقاً – على حدّ قول الدكتور محمد النويلي – أي, إنه لا يكتفي بنقل حاله ومعاناته كمعلومة, بل يخلق في الآخرين نظير تلك الحالة, فيتفاعلون معه ويتعاطفون بعيداً عن حسابات الآراء والمعتقدات.
إنّ الأدب يمثل نشاطاً إنسانياً مرتبطاً بالحياة الاجتماعية , ومرافقاً لها , وفعّالاً فيها , حيث يمكن أن يؤثر في هذه الحياة , فيغيّر في ظروفها وشروطها, وبالتالي يبدل حالها. وإذا استطاع الأدب أن يغيّر ويبدل ويضفي أشياء جديدة على الحياة , وبالتالي يكون سبباً من أسباب الفعل, عندها يكون قد أدى وظيفةً, وحقق غايةً .
غير أنّ آراء النقاد ومواقفهم تتباين أولاً, في فكرة وجود وظيفة وغاية للأدب , وثانياً حول طبيعة هذه الغاية أو الوظيفة. هل تقتصر فعالية الأدب على المتعة الجمالية فقط ؟ أم أنها يمكن أن تلبي حاجات نفعية, ذات قيم أخلاقية أو تعليمية أو غير ذلك ؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أن يُؤخذ في الحسبان الوعي الفكري , أو الزاوية التي ينظر من خلالها إلى العملية الإبداعية. ولقد تحدثنا سابقاً عن النظريات الفكرية الثلاث : نظرية المحاكاة , نظرية التعبير , ونظرية الانعكاس, وعن رؤية هذه النظريات للآداب والفنون والتي تجلت في المذاهب الأدبية أو المدارس الأدبية الرئيسة الثلاث: الكلاسيكية, الرومانسية, والواقعية.
في كلّ الحالات, يجمع الدارسون على أن طبيعة الأدب ووظيفته متلازمتان – كما ورد في كتاب نظرية الأدب لـ ” رينيه ويليك و أوستن وارين “, لأنّ طبيعة الشيء تنتج من استعماله , فهو ما يفعله . أي, إنّ استعمال الأدب ينتج من طبيعته, لأن الاستخدام الأمثل لكلّ موضوع إنما يكون حيث يستعمل لما وُضِعَ له أصلاً. ويمكن أن يستخدم استخدامات ثانوية أخرى . هذا يعني أنّ زاوية الرؤية التي نحدّد من خلالها تعريفنا للأدب, هي الزاوية نفسها التي تحدّد وظيفة الأدب
فإذا كان الوعي المثالي الموضوعي الذي تجسّد فكرياً في نظرية المحاكاة عند أفلاطون هو المنطلق, فإنه يكون على الفنان الأديب أن يسعى لتقديم الحقيقة لعلّه يقترب من الصورة المثلى, أو من المثل الأعلى الموجود خارج ذواتنا . من هنا طالب أفلاطون الشاعر بأن يُسهِمَ في جعل الناس أكثر عقلانية, عبر الابتعاد عن العواطف . وهو بذالك يشير إلى وظيفة تعليمية أخلاقية, يمكن للأدب أن يؤديها إذا هو التزم بكل الضوابط والقوانين التي تجعل الإنسان أكثر جمالاً وأكثر صدقاً وأكثر قوّة …إلخ . ولقد تجلت هذه الغاية الأخلاقية في المراحل التي أتت بعد ذلك عبر ما سمي ” الوظيفة التعليمية الدينية ” وهي عملياً شكل من أشكال الربط بين القيم الدينية والقيم الأخلاقية . هنا يمكن أن نشير إلى الصلة المتينة بين الشعر والدين . وهي صلة نشأت منذ وجِدا؛ حيث صِيغت التعاليم الدينية, والطقوس, والصلوات, في بنية شعرية, على شكل أناشيد, أو مزامير, أو موشحات, في معظم الديانات السماوية, والوضعية؛ وهي بنية تُسهم بما تتضمّنه من إيقاع و موسيقى وأنغام في عملية حفظ هذه التعاليم والطقوس و الصلوات؛ والديانات كلها إنما هي مجموعة من القيم السامية الإنسانية, التي تؤكد ضرورة الوصول إلى الجوهر الحقيقي للإنسان, وهو الخير والحبّ والجمال .
ولقد كان هذا الجانب الوظيفي الأخلاقي هو الأساس الذي حكم أفلاطون وفقه على الشعر والشعراء فأقرّ لبعضهم القيمة والمكانة , وطرد بعضهم الآخر من مدينته الفاضلة لأن أشعارهم تنمّي عواطف الإنسان على حساب عقله , فيبتعد عن القيم الفاضلة وعن الحقيقة. ثمّ تطورت نظرية المحاكاة هذه لتصبح وظيفة بذاتها , وقد أشار إلى ذلك عدد من الفلاسفة والنقاد وحدّدوا الفرق بين الأدب وبقية الفنون التي تحاكي الأشياء مثل النحت والتمثيل بالأداة ” اللغة ” فقط . .وقد أشار الفارابي إلى ذلك بقوله عن الشعر ” إنه محاكاة بالقول – يقصد الشعر- والمحاكاة بقولٍ, هو أن يؤلف القول الذي يصنعه, أو يخاطب به, من أمور تحاكي الشيء الذي فيه القول , وهو أن يجعل القول دالاً على أمور تحاكي ذلك الشيء. “.
ونلحظ تطور فكرة المحاكاة الأفلاطونية على يد تلميذه أرسطو, الذي تجاوز بها حدود ما هو كائن في الواقع ليحاكي ما يمكن أن يكون . وبما أن المحاكاة تتوجه نحو نقل مظاهر الأشياء وخيالاتها الحسية فإن وظيفتها عند أرسطو إدراك جوهر الحقائق , هي لا تحاكي الطبيعة فقط ,وإنما تساعد على فهمها , وتكشف جوانب النقص فيها, وتسعى إلى إتمامها وإكمالها. فالأدب إذن يجمّل الطبيعة ويهذبها.
ويشير أرسطو إلى وظيفة التطهير, وهي تعني أن وظيفة الأدب إثارة عاطفتين مختلفتين, ومن ثمّ تنقية هاتين العاطفتين, وتحقيق توازن بينهما , إنهما عاطفتا الشفقة والخوف. الشفقة عاطفة الإنسان تجاه الآخر, والخوف عاطفة الإنسان تجاه نفسه. وهاتان العاطفتان تنميان الروح والنفس وتنقّيهما من كل الانفعالات, حيث لا ينبغي أن تبقى العواطف مكبوتة حبيسة , بل يجب تفريغها وهذا أمر يتم بمشاهدة التراجيديا ” المأساة ” وفي النتيجة يحس الإنسان بالراحة والسعادة, لأن ما حدث قد حدث لغيره, مع أنه كان يمكن أن يحدث له.
ولقد أشار اليونانيون القدماء إلى وظيفة أخرى للشعر هي الترفيه أو التسلية أو الإضحاك , وجعلوا الكوميديا جنساً أدبياً يؤدي هذه الوظيفة , ولكن هوراس الشاعر اليوناني الكبير قَرَنَ هذه الغاية بالفائدة حيث قال : ” الشعر عذب ومفيد “. هذه العذوبة هي التي تولّد المتعة والتسلية . ولكن الترفيه أو التسلية ينبغي أن لا يقلل من القيمة الفنية للعمل . ولذلك يمكن ملاحظة اندماج المتعة و التسلية بالفائدة في الأعمال الأدبية الناجحة , وتبدو المتعة حينها أكثر سمواً ورفعة . والأدب المسلي يجسد جانباً من جوانب الحياة , وهو في الغالب يجسد المدهش والغريب والشاذ, أي إنه يتناول نماذج فردية, ولكن ينبغي لهذه النماذج الفردية أن تتجاوز حدود الذات . ومن هنا كانت هذه النماذج الأدبية مثل: الأبله, والبخيل, والحالم, وغيرها قادرة على تجاوز محلّيتها لتصبح شخصيات أدبية إنسانية . وقد يجد بعض القرآء متعتهم بالهروب من الواقع القاسي الذي يعيشون فيه إلى عالم عاطفي مثير يقدمه لهم الأدب .
أمر آخر هو أن شخصيات الناس وطباعهم وأذواقهم متعددة متباينة متنوعة من هنا لا نستطيع أن نقول إنّ ما يسلي أو ما يضحك أو ما يمتع هو واحد عند كل الناس . إنه متدرّج متنوع أيضاً . يبدأ بالمضحك البسيط الساذج ويرتقي إلى البنية الفنية الراقية التي تولّد لدى قارئها متعة سامية , وقد يصل المضحك إلى حدّ التداخل مع المبكي .
وهناك أيضاً الوظيفة المعرفية . فالأدب شكل من أشكال المعرفة , وهو ألصق بالفلسفة من التاريخ – كما يقول أرسطو – التاريخ يروي الأمور التي حدثت , أما الأدب فيتناول أموراً يمكن أن تحدث . وقيمة الأدب هنا تأتي من كونه يمنحنا المعرفة بأمور وخصوصيات خارج نطاق العلم والفلسفة . ويمكن أن تقدم لنا الأعمال الأدبية الناجحة حقائق ومعارف عن طبيعة الحياة البشرية , والنفس الإنسانية أكثر مما يقدم أي علم آخر مثل علم النفس أو علم الاجتماع . يمكن أن نذكر هنا أعمال الكاتب الروسي الكبير دوستويفسكي : الجريمة والعقاب , الإخوة كارامازوف , الأبله , المقامر …إلخ
أما المثاليون الذاتيون أصحاب نظرية التعبير فيرون أن الوظيفة الأساس للأدب إنما هي التعبير والتوصيل أي إن الأدب هو شكل من أشكال التعبير عن حياة المؤلف وانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره وعواطفه وما يدور في ذهنه . إنه موقف الرومانسيين . هذا يذكرنا بالنظرة إلى الأدب على أساس أنه شكل من أشكال التواصل اللغوي بين مرسِل ومرسَل إليه, وإلى الحديث عن الوظائف التي يمكن أن تؤديها اللغة إذا نظرنا إلى مكونات عملية التواصل هذه . إنها الوظيفة التي تؤديها اللغة إذا نظرنا إلى الرسالة ” النص ” ذاتها ويسمها الدارسون الوظيفة الشعرية , وهي التي تتمحور حول العبارة الشعرية اللفظية التي يكتبها المؤلف , مع الإشارة إلى أن النصّ الأدبي مهمته إيصال تعبير أدبي .
وهناك من النقاد من لا يرى للأدب أية وظيفة ,وهؤلاء هم البرناسيون – نسبة إلى جبل البرناس في اليونان وهو موطن آلهة الشعر كما تقول الأسطورة – حتّى إنهم يتجاوزون الفكرة الرومانسية, عندما يرون الشعر غاية في ذاته, لا وسيلة للتعبير عن الذات. أي إن الأدب لا يهدف إلى عرض أفراح الفرد وأحزانه ومعاناته. غاية الشعر نحت الجمال فقط. يقول بودليير : ” ليس للشعر غاية وراء نفسه, وإذا وجدت غاية كهذه عندها تنقص قيمته الشعرية. ” ولقد شبّه الناقد تيوفل الشاعر بالنحات “, الذي يهتم اهتماماً شديداً بالشكل, فينحت شعره كما ينحت المثّال تمثاله. وكل فنان يهدف إلى غير الجمال فليس بفنان “. أما برادلي فيرى أن الشعر عالم في ذاته, مستقلٌ تماماً عن الوجود الخارجي وليس انعكاساً للواقع أو موازاة له . ويقول الناقد والشاعر هيوم : أنا أعترض على الميوعة, التي لا ترى القصيدة إلا إذا كانت تنوح أو تعول على هذا الشيء أو ذاك” .
أما أصحاب الوعي المادي العلمي فقد ربطوا كل أشكال النشاط الفكري والإبداعي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية, ونظروا إلى الفنون والآداب على أنها انعكاس لطبيعة الصراع الاقتصادي والاجتماعي في البنية التحتية للمجتمع, من هنا كان على الفنان أن يساهم عبر فنه في تطوير الحياة وتخفيف حدة التناقضات والصراعات من خلال رصد المشكلات التي تثقل حياة الناس, وإبراز السلبيات من أجل فضحها أولاً, وتجاوزها ثانياً. وهذا ما تجلى واضحاً في المراحل الأولى من تطور المذهب الواقعي. في المرحلة الثانية تجاوز الأدباء مهمة رصد الواقع كما هو إلى مرحلة رصد الواقع كما يجب أن يكون, وكأنهم يفتحون عيون الناس على إمكانية وجود حياة أخرى يمكن أن يعيشوها, فواقعهم ليس قدراً لا مفرّ منه. وفي المرحلة الثالثة – الواقعية الاشتراكية – تجاوزوا ذلك إلى تقديم المشكلة, واقتراح, أو إيجاد حلول لها . وهذا الحل يكون على يد البطل الإيجابي الذي ينهض من بين صفوف الناس العاديين فينمّي وعيه, ويثقّف نفسه, ويجمع معارفه حتى يمتلك القدرة على الفعل والتغيير, فيغيّر . وهذه الوظيفة تبدو واضحة في كل أشكال الأدب الملتزم بقضايا المجتمع والوطن والناس مثل الأعمال التي أبدعها شعراء الأرض المحتلة : محمود درويش , سميح القاسم , توفيق زياد ,غيرهم. أو إبداع الشعراء الذين تحدثوا عن القضايا الاجتماعية, مثل الفقر والتشرد والجهل والقهر والاستغلال وغيرها. إذن هنا تبدو مهمة الأدب والأديب أكثر وضوحاً إنها حضٌ وتحريض على الثورة ضدّ المستعمر وضدّ المستغل وضدّ القهر والجهل.
في كل الحالات يمكن أن نتذكر هنا المقولة المشهورة : الشعر ديوان العرب , والشاعر العربي القديم كان لسان حال قومه , والمدافع عنهم , إنه أقرب إلى ما تمثله وزارة الإعلام الآن , وهذا أمر كان في الماضي وما زال إلى الآن , وسيبقى الأمر كذلك . لأن الفن مرتبط بالإنسان وبحياته ونشاطه العملي والفكري ولاقتصادي يتأثر به يرصده ويسعى إلى تطويره.
كل التفاعلات:
أنت، ومنيرة أحمد، وأحمد عثمان و٧٢ شخصًا آخر