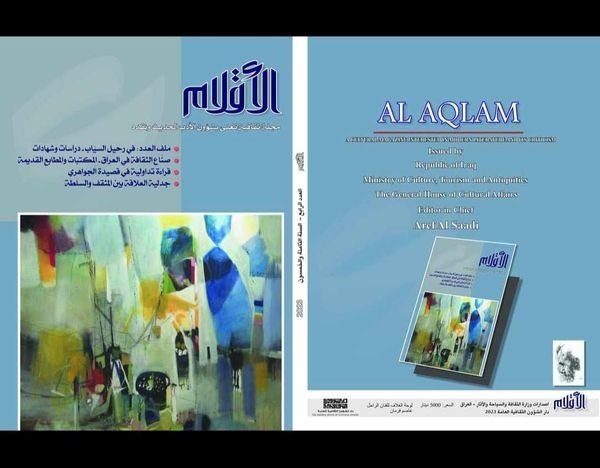خلودهُ الشعريّ الكبيرُ, أمْ وجعهُ الإنسانيّ ونكوصُهُ العاطفيّ المَريرُ؟
د. جبَّار ماجد البهادلي / ناقدٌ وكاتبٌ عراقيّ
لا يختلف اثنان من الأُدباء أو النُّقَّاد المُحدثينَ على كون بدر شاكر السّيَّاب (1926- 1964م) شاعراً وإنساناً, ولكنَّ المختلف عليه أنَّ السيَّاب عاشَ شاعراً فذاً كبيراً مِقداماً لا يُشكُّ بشاخصية مكانته الخُلودية الرفيعة الرائدة, ولم يعشْ إنساناً مُنعَّماً مُرفَّهاً, بل عاشَ إنساناً حزيناً فقيراً مُعدماً مُوجعاً مأزوماً بالمعنى الإنساني المُهين الذي يقابل مكانته الشعرية الخالدة المتفرِّدة في أدبيات عصره الحداثوي المتجدِّد. ويبدو أنَّ اللهَ قد خلق السيَّاب ليكونَ شاعراً عظيماً مدوِّياً لا إنساناً مُهاباً معززاً مُكرَّماً كبقية خلق الله,وإنَّما عاش الحياة مظلوماً ذليلاً ارتكاسياً مقهوراً ليس له من الدنيا سوى الحزن والشقاء الأبدي والعذاب النفسي والألم الجسدي الذي كُتِب على صحيفته الإنسانية!
ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال الإشكالي الجدلي الذاتي في ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى؛ ذلك أنَّ السيَّاب قبل أنْ يكون شاعراً كبيراً فحلاً ذكورياً مبدعاً مخلَّداً امتلك رابية الشعر الحديث وريادته الأولية مع شريكته نازك الملائكة كان أوَّلاً وآخراً إنساناً آدمياً طبيعياً؛ ولكنْ أيَّ إنسانٍ هذا الذي تنعَّمَ رَحيقَ الخلود الإبداعي بشعريته الفنيَّة الطاغية, وذاق علقم نقيضها الإنساني, فعاش مرارة العيش المُذِلّ البطيء الموجع المتعثِّر الخائب. فأمَّا الموت أو الحياة, مادام الصراع قائماً بين (أكونُ أو لا أكونُ), وإلَّا فَلا لحياةٍ ينقصها العيش الهانئ الرغيد.
من يُجيل التعمُّق الدقيق في استقراء شخصية السيَّاب الثقافية, ويبحث تجلِّياً عن آفاق تركيب كينونته الإنسانية الكبيرة الثرَّة, سيكتشف من خلال حفرياته الأثرية لتجربته الشعرية ذلك المعادل الموضوعي المهمّ الذي يجمع بين طرفي المعادلة سلباً وإيجاباً. إنَّه البون الشاسع للمِساحة الحقيقية بين الذات الشعرية الفاعلة والذات الإنسانية المتفاعلة التي انتجت لنا شاعراً مُبهراً فذاً لا يمكن استنساخ صورته الفنيَّة بنسخةٍ إبداعيةٍ حداثوية مَرةً أخرى. إنَّه السيَّاب أيقونة عصره وهبته التي لا يمكن أنْ تتكرَّر لشاعرٍ آخر بنفس المزايا والصفات الشاعرية المتوافرة.
فمن دلائل هذه الرمزية المُخلَّدة التي صنعت لنا شاخصاً فنارياً خلاقاً بارزاً, وثوقية السيَّاب القويَّة بنفسه الأبيَّة المُقدامة رغم خوائها الجسدي المتنامي, وسعةُ درايته الفكرية والثقافية التبصيرية الكبيرة الهُمامة التي حفَّزته على كيفية تخليق شعرٍ حُرٍّ جديدٍ يواكب المرحلة ويكون له فيه أثره الإبداعي الواضح وبصمته التوقعية الخاصة به التي تشير إليه زمكانياً على مرأى تطاول الزمن وتعدُّد أمكنته الزمانية المتعاقبة.
فالسيَّاب على الرغم من كونه -زمانياً- ناهز الثامنة والثلاثين عاماً, ولم يتمّ عقده الرابع من العمر, فضلاً عما كان يمرُّ به من أحداثٍ صحيَّةٍ جِسامٍ, ومتاعب نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية وماديةٍ عسيرةٍ جَمَّةٍ, فقد جعل الكثير من الحقول الدلالية والسِّمات اللُّغوية تُهيمن بقوةٍ على نفسه الظمأى, وتُلقي بفيء ظلالها الوارفة على روافد شعريته أكثر من غيرها تأثيراً وانتشاراً ورواجاً واستقداماً. لاسيَّما تلك الألفاظ التي تُشير معانيها الدلالية الرحبة إلى الحبِّ والإنسانية والشقاء والفقر والفاقة والعوز والتقرُّب والضياع والتشتت والرجاء والتمنِّي بنوعيه.
لقد كان فقدان السيَّاب لأُمِّه وموتها وهو في مقتبل الساسة من عمره, ومن ثُمَّ ابتعاده الاضطراري عن والده, وفقدانه الرحيم أيضاً لجدَّته من أُمّه التي كانت تمثِّل الحضن الدافئ الأثير والأخير لملاذه أعظم الأثر في حياته الشخصية. وكانت لهذه الأحداث السريعة المتلاحقة تداعياتها النفسية الخطيرة والكبيرة على حياته الاجتماعية, وعلى أُسلوبيته المعجمية في شعره. ومثل هذه الأحداث الذاتية تشير بوضوح تامٍ إلى تداخل ذاته السيرية الخاصة بآفاق ذاته الشعرية العامة. وهذا يعني همينة الشعور الإنساني الفردي الطافح وطغيانه اللَّافت على سطح الشعور الموضوعي في شعره الإبداعي. مما جعل من تلك الدلالات الإنسانية أنْ تكون أوسع مما هي عليه في نتاجاته.
لا شكَّ أنَّ هذا الفقد الإنساني المرير للأحبة المُقَرَّبينَ من السيَّاب(الأُمُّ والأبُ والجَدُّ), وذلك اليُتم المُبكِّر والحزن المتأصِّل في نفسه الطفولية, وتلك المشاعر الفياضة الممزوجة بالألم الروحي وخيبات الوجع, وفقدان الأمل المتكرِّر نتيجة تعاقب أحداث الزمن وامتداد الشعور النفسي بذمامة الخَلْقِ الصوري لهيأة شكله الخارجي.
هذه كلها عوامل اجتماعية ونفسية وإنسانية ملحِّة ومؤثّرة وقاهرة متساقطة أُودتْ بشخصية السيَّاب الإنسان المُتعب الجريح,وليس الشاعر المُذهل الشفيف, ودفعته إلى الحاجة الكبيرة والمستمرَّة في تعويض تلك النكوصات المؤلمة ومواجهة كوابح الفشل الاجتماعي غير المناسب والحرمان الذي فرضه عليه ضمير الزمن وتطاوله غير الرحيم إلى التفكير جديَّاً ببدائل معنوية أخرى تُشبع حُبَّ رغباته الذاتية, وتسدُّ فراغ نقصه وحرمانه الإنساني وحاجته الفردية المتعطِّشة إلى رواءٍ دائمٍ في الحبِّ والحنان والعشق والهُيام بالمرأة الكائن الرمزي التي وجد فيها ما يُبدِّد غيوم غربته ويكشف للناس عن صور حُجُبها الخفية وشبحها المتلاحق. وعلى الرغم من ذلك الهوس فإنَّ الحبَّ لم ينصفه أبداً, وعرف عن السيَّاب بأنَّه رجل الحرمان الذي اكتوى بلهيبه الَّلاذع في انتقامه لحرمانه.
وكلُّ تلكَ الممكنات والرغائب تظهر من خلال تغلبه على كَبته الانفجاري الذي استحال إلى عاطفةٍ رومانسيةٍ جيَّاشةٍ سيطرت على نفسه الأنوية والشعرية وحَزَبَتهَا كليَّاً, ثمَّ صارت شعوراً عاطفياً جميلاً محبَّباً لدية في الميل الشديد والتولُّع بالمرأة الأُنثى والتغزُّل بالفتيات الجميلات والحسناوات في محيطه المكاني والزماني.إذ دفعته الأنا الشاعرية التي هي انعكاس للأنا الذاتية النفسية إلى الإعلان عن إفشاء شعريته وشعوره المغتبط بحسد ديوانه الذي بات ينتقل بين أنفاس صدور الفتيات القارئات والمحبَّات لشعره الغزلي, وقد جسَّد صور تلك المعاني بقوله:
دِيـوَانُ شِـعرٍ مِـلؤهُ غَـزَلٌ بَينَ العَذَارى بَاتَ يَنتقِلُ
أنفَاسِي الحَرَّى تَهِيمُ عَلَى صفحَاتهِ وَالحُبُّ وَالأَملُ
لم يكتفِ السيَّاب بذلك التصريح المُعلن بهوى تباريح تلك الرومانسية الحالمة, فقد أخذته التمنِّيات والأشواق والرغبات الملتهبة إلى أنْ يكون كديوانه الشعري, فراحَ يُردِّد تمنياته الآسرة في مطلع قصيدته التي يهجس بها :
يَا لـيتَنِي أْصبَحتُ دِيَوانِي لَأفرَ مِـنْ صَـدرٍ إلى ثَـانِ
السيَّاب من خلال دراسته بدار المُعلِّمين العالية والتحاقه بها عام (1943م) في قسم اللُّغة العربية ومن ثمُّ انتقاله إلى قسم الُّلغة الإنكليزيَّة, تلك المؤسسة التعليمية التي تخرَّج فيها ونال الإجازة الدراسية كانت تعدُّ فضاءً واسعاً, ومنجماً للإبداع والجمال الفكري الثرِّ وقتذاك لمختلف الاتجاهات السياسية اليسارية والمدارس الفنيَّة. كان السيَّاب فضلاً عن ذلكَ التوجُّه الإبداعي الفنِّي الجمالي والآيدلوجي السياسي شغوفاً ومندهشاً بحبِّ المرأة الرمز الأنوثي معشوقةً لا عاشقة من طرف خيطٍ خفيٍّ واحد يشعر به, كونه إنساناً مُحبَّاً للحياة لا كونه شاعراً مُبدعاً.
ويبدو أنَّ شعور السيَّاب العاطفي هذا قد حَفَّزهُ إلى التقرُّب من الشاعرة لمعية عباَّس عمارة(1929-2021م) ابنة خالة الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد(1930- 2015م). ولميعة تُعْرَفُ بأنَّها ذات الأصول الصابئية والانتماء الإثني المندائي. وكان السيَّاب يظنَّ كلَّ الظنِّ في تقرُّبه إليها أنَّها تُحبُّهُ جدَّاً وتُبادله المشاعر العاطفية ذاتها, الأمر الذي جعله عاطفياً يبني عليها جسوراً متينةً من أوصال الحبِّ والأحلام الوردية المحبَّبة. لكنَّ السيَّاب في الوقت ذاته لم يضع في حساباته الخاصة ذلك البُون البُعدي المَسافي الواسع بينه وبينها؛ كون لميعة من ديانة إثنية صابئية أُخرى غير ديانته الإسلامية التي تحول دون الارتباط بها اجتماعياً وإثنياً وعُرفيَّاً.
ومما هو معروف في الأوساط الأدبية والثقافية أنَّ لميعة امرأة سومرية جنوبية وشاعرة مجدِّدة من شواعر دار المُعلِّمين العالية الجميلات جدَّاً التي يتمنَّاها أيُّ مبدعٍ آخر؛ وذلك ظنَّاً من السيَّاب أنَّ الحبَّ لا يعرف المسافات العقائدية والانتماءات الذاتية والأصول الروحية المُتجذِّرة التي تضع العقبات في الطريق المؤدِّي للحياة المسالمة.
والحقيقة المؤسفة جدَّاً والتي تحتاج إلى دراسة وتوثيق دقيقين أنَّ لميعة عبَّاس عمارة كان تبادله المشاعر نفسها, وتهتمُّ ببدر شاكر السيَّاب اهتماماً ملحوظاً , وتلتقي به باستمرار , وهذا مما جعل السيَّاب يتعلَّق بها كثيراً, ويجعلها نصاب قلبه وروحه الموجعة المستهامة بها. وإلَّا ما تفسيرُ ذلك التواصل العاطفي والإبداعي مع لميعة؟ وهل كان لمصلحةٍ أو لغايةٍ ما أخرى تبتغيها لميعة من السيَّاب على الرغم من كونها شاعرةً حداثويَّةً خمسينية؟
وبعد عقود أخرى من الزمن خلتْ على وفاة السّيَّاب(رحمهُ الله) تظهر لميعة عبَّاس عمارة في إحدى لقاءاتها الصحفية الحوارية, فتستدعي من خلال سؤالها تلك الواقعة العاطفية الحدثيَّة المؤثِّرة وتنفي بإصرارٍ عجيبٍ ومبرَّرٍ علاقتها وحبَّها الصادق للسيَّاب وتقرُّبها عاطفياً وإنسانياً منه. والحقيقة أنَّ موقفها هذا زادَ من الطين بلةً وتعقيداً في استكبارها وتنمّرها وغرورها الشخصي حيال السيَّاب. فتقول مُصرِّحةً للمتلقِّي ومعلنةً للملأ أنَّها كانت تستعطفه وتحنو عليه إنسانياً نتيجة شعوره بالفراغ العاطفي وإحساسه بنحالة عيب هيأته التي تفرُّ منها النساء.
ويغلب على ظنِّي وترجيحي كثيراً أنَّ لميعة لم تكن موفقة تماماً في تصريح رأيها الناري هذا, ولم تكن أيضاً منصفةً في التعبير عن صدق مشاعرها في عدم حبَّها للسيَّاب, وإلَّا لماذا استمرَّت في إبداء مشْاعرها للسيَّاب مدَّةً طويلةً تمدَّه بالمشاعر والأحاسيس الذاتية؟ وهل كان ذلك إحساناً بريئاً منها لزميلها السيَّاب, أم هروباً من الحقيقة المُرَّة تُجاهه؟ ولو كان السيَّاب الآن يعيش حيَّاً وَعَلِمَ بما تخفيه لميعة من مشاعر كاذبةٍ واستحسانٍ مُذلٍّ مُهينٍ له في واقعة حبَّه لها لردَّدَ مأساة قوله الشهير عندما علم بدنو موته(المَوتُ أهونُ من خِطِيَّةِ),بل الذلُّ أهون من ذلك.
كلُّ الحقائق الأدبية والشعرية التاريخية تُشير بوضوح متينٍ إلى أنَّ هناك جذورَ علاقةِ حبٍّ متبادل بين السيَّاب ولميعة. وعلى الرغم من كلِّ ذلك أنَّ لميعة تؤكِّد بأنَّ علاقتها به كانت هامشيةً وبريئةً؛لكنَّ وثيقة القصائد المتبادلة بينهما تؤكِّد تلك العلاقة وتفضح سِتارَ إخفائِها الحقيقي. والدليل على حقيقة تلك العلاقة الذاتية بينهما, والتي يؤكِّدها السيَّاب نفسُّه, هي قصيدته الموسومة بعنوانها (أحبِّيني), الدالة عتبتها عليها, والتي يكشف فيها عن حبِّه لها بعدما رفضته جميع الفتيات الحبيبات قبلها.وهذا يشي بأنَّ لميعة لم تنصف السيَّاب حبَّاً مثلما لم تنصفه النساء:
وَمَا مِنْ عَادتِي نُكرانُ مَاضي الَّذي كَانَا
وَلَكِنْ كٌلُّ مِمَنْ أَحبَبتُ قَبلَكِ مَا أَحبُونِي
وَلَا عَطَفُوا عَلَيَّ عَشِقْتُ سَبعَاً كُنَّ أحيَانَا
تَرَفُّ شُعورُهُنَّ عَلَيَّ تَحمُلنِي إلَى الصِّينِ
سَفَائنُ مِنْ عُطُورِ نِهُودِهُنَّ أَغوصُ فِي بَحرٍ
مِنَ الأوهَامِ وَالوَجدِ
فَألتقِطُ المَحارَ أَظنُّ فِيهِ الدُّرَ ثُمَّ تَظلُّنِي وَحدِي
ويبدو أنَّ لميعة عبَّاس عمارة على الرغم من كونها شاعرةً جريئةً متحرِّرةً بَاسلةً مِقدَامَةً أحدثت انقلاباً تفجيرياً ريادياً بتأنيث قصيدة الشعر العربي الحداثوية الذي أسَّست له وانتهجته زميلتها الشاعرة العراقية المجدِّدة نازك الملائكة. فإن لميعة قد خطَّت لها طريقاً خاصَّاً في كسر جدار المألوف الشعري من خلال قصائدها الفصيحة والعامية التي عكست روحها المرحة الطاغية عليه. إلَّا أنَّها لا تريد تأكيد حقيقة صداقتها الأثيرة وحبِّها للسيَّاب لسببين مهمين أولهما, إنَّ لميعة شعرت ببعد المسافة بينها وبين السيَّاب من حيث انتمائها الديني كونها امرأةً صابئيةً مندائيةً تَحُولُ شرعنةُ تقاليدها الدينية والعُرفية الزواج برجل من غير المِلَّةِ أو الطائفة, وبدرٌ رجلٌ مُسلمٌ.
أقول هذا وأُؤكد أنَّ لميعةَ امرأةٌ جريئةٌ ثائرةٌ باستطاعتها إعلان الثورة على سطوة تقاليدها الدينية وأعرافها الاجتماعية غير أنَّها عدلت عن تقرُّبها العاطفي الوثيق من السيَّاب واكتفت بالقول بأنًّها تعتزُّ بصداقتها للسيَّاب الشاعر, وأنَّ علاقة حبِّها له علاقة بريئة, والحقيقة أنَّ هذا الأمر مرفوض ومستبعد جدَّاً ولا يمتُّ بصلةٍ للحقيقة.
أمَّا السَّبب الثاني, فيكمن هاجسه في نفس لميعة وذاتها الأنوية المتعالية؛ كونها امرأةً تشعر بالزهو والخُيلاء والكبرياء. وربَّما يدفعها الغرور والنرجسية بأنها جميلة وأنيقة ذات روحٍ مرحةٍ ومزاجيةٍ كبيرةٍ وعاليةٍ, ومن عائلةٍ أدبيةٍ وفنيَّةٍ ثَريَّةٍ معروفةٍ في الجَنوب. فلا يَليَق بها نفسيَّاً واجتماعيَّاً ودينياً الارتباط برجلٍ مريضٍ مُعدَمٍ حزينٍ مِكدودٍ, مثل السيَّاب النحيف جسماً والناحل طولاً والذميم شكلاً وصورةً. ربَّما دفعها كبرياء إحساسها وشعورها المتأخر بالأنا بعدم الارتباط ببدر السيَّاب الإنسان وليس الشاعر,وربَّما سوف تُلامُ وتُعيَّرُ بهِ زوجاً لها.
لقد تسايرَ الجانبان الموضوعي الإبداعي والإنساني الاجتماعي السِّيري جنباً إلى جنبٍ في شعر السيَّاب الثرِّ الغزير, ذلك الإرث الفنِّي الخلودي الذي خلَّفه وراءه.فالسيَّاب على الرغم من قصر سنين عمره القليلة واستشراء عذاباته الأليمة, وكثرة مصاعب حياته وتعدُّد إخفاقاته الاجتماعية, لا سيَّما شعوره العاطفي الطفولي المبكِّر بالحرمان من حنان أُمِّه وأبيه. فضلاً عن حزنه وَفُقره الاجتماعي واستفحال مرضه المزمن وتغرُّبه الذاتي وكثرة تحولاته الآيدلوجية والسياسية وانتقالاته المرحلية الزمكانية.
فقد كانت هذه الأسباب الإنسانية مجتمعةً مُحَفِّزَاتِ وعيٍ ودلائل إبداعٍ واثبةً كبيرةً على تسارع وتيرة خطى عبقريته الشعرية الفذَّة ونضوج فكره وسطوع موهبته واتِّساع ثقافته المعرفية المكتسبة التي تميَّزت بها آفاق معجمه الشعري وطُبعت بها أسلوبيته الشعرية المعاصرة.
لقد كان لوقع تلك الظروف المريرة التي عاشها بدر شاكر السيَّاب أثرٌ بالغٌ وكبيرٌ وصدىً محكيّ مؤثِّر في مراحل حياته العمرية المتفاوتة التي انعكست ظلالها في مرآة شعرة الجمعية. فقد جسَّد السَّياب -شاعراً وإنساناً- بعينه الشعرية الثالثة تلك الظلال الجمعية المُلتقطة والمَحطَّات والمرافئ الحياتية الداخلية والخارجية الوارفة الأثر في شعره بمختلف صورها الروحية والنفسية وآلامها الجسدية الموجعة التي باتت همَّاً شعرياً مُلحَّاً ومُؤرِّقاً.
فقد أنتجت لنا تلك المراجع والأنساق الثقافية الحياتية قصائد شعريةَ مذهلةً وأفرزت مطولاتٍ ملحميةً أسطوريةً مدهشةً على مستوى الحداثة الشعرية العربية كوّنتها فرادة تجربته الذاتية في مسار قصيدة التفعيلة الحرَّة الجديدة التي هو أحد مبدعيها وروَّادها الأوائل الثلاثة,(بدر, ونازك, والبيَّاتي) تطويراً في العراق والعالم العربي الكبير.
إنَّ ما يُميِّز أسلوبية السيَّاب الشعرية تعدُّد موضوعاتها الشعرية وتجدُّد أغراضها الفنية المُكثَّفة بشكلٍّ لافتٍ مثير من خلال احتشاد الألفاظ المنتظمة واصطفاف المعاني الدالة حقولها اللُّغوية على موضوعاتٍ عديدةٍ مثل, (الألم, والموت, والعذاب, والجراح, والرزايا, والمصيبات, والظلام ,والردى, والهلاك).ونستحضر للتمثيل في هذا المجال مقطعاً شعرياً رمزياً من قصيدة (سِفر أيوب) المعبِّرة عن معاناة السيَّاب الصارخ فيها من قاع الألم:
لَكَ الحَمدُ مَهمَا استطَالَ البَلاءْ
وَمَهمَا اِستبدَّ الأَلَمْ
لَكَ الحَمدُ إنَّ الرَّزايَا عَطَاءْ
وإنَّ المُصيباتِ بَعضُ الكَرَمْ
أَ لَمْ تَعطِنِي أَنتَ هَذَا الظَّلَامْ؟
وَأعطيتَنِي أَنتَ هَذَا السَحَرْ ؟
فَهَلْ تَشكرُ الأَرضُ قَطرَ المَطَرْ
وَتَغضبُ إنْ لَمْ يَجدْهَا الغَمَامْ؟
شُهُورٌ طِوَالٌ وَهَذِي الجِرَاحُ
تُمَزِّقُ جَنبِيَّ مِثلَ المَدَى
وَلَا يَهدَأ الدَّاءُ عِندَ الصَبَاحْ
وَلَا يَمسحُ اللَّيلُ أوجَاعَهُ بِالرَّدَى,
وَلَكنَّ أَيوبَ إِنْ صَاحَ صَاحْ
لَكَ الحَمدُ إنَّ الرَّزايَا نَدَىً
وإنَّ الجِراحَ هَدَايَا الحَبِيب
إذا كان الحبُّ بمعناه الحياتي المتنامي هو المسيطر على قصائد السيَّاب (الزمكانية والرمزية والاغترابية) في المراحل الأولى من سنين شباب عمره, فإنَّ الموتَ بمعناه الدلالي الموجع الكئيب يعدُّ من أكثر الحقول الدلالية حضوراً وطغياناً وظلاميةً على حساب ذكر نقيضه الحبّ في القصائد الأخيرة من تعاقب حياة السيَّاب المتهالكة.
حدث كلُّ ذلك نتيجة استمراء الألم في حياته وظروفه الاجتماعية والنفسية والجسدية البالية, فضلاً عن وسوء حالته الصحية السيِّئة. وعلى الرغم من كلِّ الخصائص الفنيَّة الكثيرة التي انمازت بها القصيدة السيَّابيَّة, ولا سيَّما فنيَّة التدفق الشعري المرتبط إيقاعياً بحركة التدفق الشعوري الذاتي, وانزياحية فعلية تحطيم رهان المألوف التقليدي والخروج عن مسار الشكل التقليدي المعجمي المتعارف عليه في حدِّ القصيدة العربية, فإنَّ الكثير من قصائد السيَّاب قد اتسمت بنبراتِ عاليةٍ من الحزن المستديم الشفيف, وَطُبعت بلمحات من سمادير الكدر الموجع.
والمتلقِّي المتابع لتجربة السيَّاب الشعرية, والمُدرِك لجراحاته يستشعر قساوة تلك الظروف التي عاشها بألم نافذ, ولا سيَّما مرضه العُضال الذي أودى به في نهاية المطاف إلى فقدان حياته وموته في(24) من شهر كانون الأول عام (1964م ).ولعلَّ قصيدة(البَابُ تَقرعهُ الرِّياحُ) تعدُّ من بين النماذج الشعرية الرثائية المعبِّرة عن فقدانه لِأُمِّه:
هِي رُحُ أُمِّي هَزَهَا الحُبُّ العَميقْ
حُبُّ الأُمومَةِ فَهيَ تَبكِي .
” آهٍ يَا وَلَدِي البَعيْدَ عَنِ الدِّيَارْ !
وَيلَاهُ ! كَيفَ تَعودُ وَحدَكَ لَا دَليلَ وَلَا رَفِيقْ”
أُمَّاهُ… لَيتَكِ لَمْ تَغيبِي خَلفَ سُورٍ مَنْ حِجَارْ
لَا بَابَ فِيهِ لِكَي أدقَّ وَلَا نَوافذَ فِي الجِدَارْ
فمثل هذه القصائد المضمَّخة بجراحات الألم المُفجع والتي صارت نسقاً ثقافياً ظاهراً ومضمراً تشي إشاراتها السيميولوجية الشعرية دلالياً وفنيَّاً بأنَّ السيَّاب آثر أنْ يخسر الحياة الفردية ليربحَ جمعياً الشعر الذي خلَّد هذه الحياة الارتكاسية الموغلة بالهمِّ والحزن الضافي. ولعلَّ هذا الصراع النفسي الداخلي الذي كان يضطرم حياة السيَّاب بين سعي الروح الشاعرية إلى التسامي الإبداعي الخلودي, وبين نوازع الجسد الصورية, هو الفارق الرمزي الدلالي الذي وشم نتاجه الشعري الكبير ببصمة إيقاعٍ أُسلوبي غير قليلٍ من ترانيم الوجع الروحي وتعاويذ التَّمزُّق النفسي الداخلي, ومحاولات الجنوح إلى واقعية الحزن المستديم الذي لا يفارق مخيلته الشعرية:
يَا رَبِّ أَيوبُ قَدْ أعيَا بِهِ الدَاءُ
فِي غُربةٍ دُونَمَا مَالِ وَلَا سَكَنْ
يَدعُوكَ فِي الدَّجَنْ
يَدعُوكَ فِي ظَلموتِ المَوتِ أعبَاءُ
نَاَد الفُؤَادُ بِها فَارحَمهُ إنْ هَتَفَا
يَا مُنجيَاً فُلكَ نَوحَ مَزِّقِ السَّدَفَا
عَنِّي أَعدنِي إلَى دَارِي إِلَى وَطَنِي
أَطفَالُ أيوبَ مَنْ يَرعَاهُم الآنَا
ضَاعُوا ضَيَاعَ اليَتامَى فِي دُجَى شَاتِ
يَا رَبِّ أرجعْ عَلَى أيوبَ مَا كَانَا
إنَّ الموازنة الرمزية التي أجراها الشاعر للمماثلة بينه وبين أيوب الرمز التاريخي الديني للصبر والعذاب من خلال تحشيده لمجموعة كبيرة من الألفاظ والمعاني الموجعة بحدِّ الألم مثل,(الداءُ والإعياءُ, والسكنُ, والدَّجنُ, والظُلمةُ, والموتُ والرحمةُ, والغربةُ, والتَّمزُّقُ, والضياعُ, واليُتمُ , والدُّجى), هيَ تثوير لمجسَّاتٍ نفسيَّةٍ صارخةٍ عبر أثير القصيدة النازف بجراحات الألم, وهي في الوقت ذاته إسناد وتعضيد وتأكيد لمتبنيات نظرية سيجموند فرويد الغريزية عن دور الأنا الشاعرية الذاتية العليا في إظهار فاعلية تلك المكبوتات النفسية الحبيسة وإحالتها من خلال توظيفها إلى ضفاف ناصية الأدب الفنِّي (المُرسل) برسالة نصيةٍ عن طريق التسامي الروحي الشعري إلى المتلقي أو القارئ(المرسل إليه).ويمكن أنْ تتكرَّر مثل تلك الألفاظ وتتواتر شعرياً في أكثر من قصيدة واحدةٍ من خلال الرموز والإشارات السيميائية الجديدة الدالة نصيَّاً على ثراء جماليات حقولها الدلالية واللُّغوية المتعدَّدة.
إنَّ إحساس السيَّاب الذاتي الأنوي المتصاعد بحبِّ الوطن والشعور بالغربة المفرطة وهواجس الانفصال عن رهان الواقع المعيش كلِّها إرهاصات شعورية نفسيَّة مُحتدمة الصراع تجلَّت واقعتها الفعلية الحدثية في معجم شعري تعبيري مكتظ المعاني بمفردات يوتوبيا الوطن والوحدة الاغتراب والعزلة والموت البطيء والوجع والحزن والخيبة والفراق. ولا شكَّ أنَّ التكرار اللَّفظي الدائم لمفردة (العراق) عند بدر شاكر السيَّاب في قصيدته (غريبٌ على الخليج), ليس سوى احتفاءِ توهُّجٍ روحيٍ ثائرٍ بالغربة الشمولية القاتلة لشعوره بهاجس حبِّ الوطن. وهي أيضاً السبيل الوحيد لإعادة الحياة النابضة لروح الشاعر التي شُلَّتْ جسداً وتمزَّقتْ نفْسَاً وضاقت عليه سُبُلاً:
صَوتُ تَفَجَّرَ فِي قَرارةِ نَفسِي الثَّكلَى عِرَاقْ
كَالمَدِّ يَصعَدُ, كَالسَّحابَةِ, كَالدُمُوعِ إلَى العُيُونِ
الرِّيحُ تَصرَخُ بِي عِرَاقْ
المَوَجُ يُعْوِلُ بِي : عِرَاقْ,
عِرَاقٌ, لَيسَ سِوَى عِرَاقْ!
البَحرُ أَوسعُ مَا يَكُونْ
وَأَنتَ أَبعَدُ مَا تَكُونْ
البَحرُ دُونَكَ يَا عِرَاقْ
بِالأمسِ حَيثُ مَرَرتُ بِالمُقهَى سَمِعتُكَ يَا عِرَاقْ
وَكُنتَ دَورةَ أُسطوانَةْ
هِيَ دَورَةُ الأَفلَاكِ مِنْ
عُمرِي تَكَوَّرَ لِيْ زَمَانهْ
فِي لِحظتَينِ مِنَ الزَّمانِ وَإنْ
تَكُنْ فَقَدتْ مَكَانَهْ
فالأفعال الزمانية الحالية والماضية المتراتبة التي حفل بها تدفق النصّ الشعري, (تفجَّرَ, يصعدُ, تصرخُ, يُعوِلُ, يَكونُ, تُكونُ, تَكوَّرَ), قد أسهمت إسهاماً كبيراً ومؤثِّراً من خلال إيقاعها الحدثي الزمني في تنامي مشاعر الشاعر النفسية المضطربة وتصاعد وتائر هجسه الداخلي في ترديد بكائه وصراخاته الحرى المدوِّية لمسامع المتلقي ونَاظِرَيهِ. ليشعرَ بعلائق روحه المتقطِّعة, ونياط قلبه المتأزِّمة المُحطَّمة شوقاً لذلك الواقع الوطن العراق.
وفي وقع هذه القصيدة البكائية الملحمية الشعورية بالذات (غريبٌ على الخليج), وبقية قصائد السيَّاب الوطنية والاغترابية الأخرى توازى الحضور الشعري بمفهومه الجمعي العام مع الحضور الجسدي الغنائي الذاتي الفاعل بمفهومه الخاص, وتساوى في حضرة مشهدية الشعر الأدبي والثقافي كلاً يكمل نسج وحدته الموضوعية الكبرى.
إنَّ حبَّ السيَّاب لوطنه(العراق الكبير) يعدُّ من السمات الدلالية المهيمنة روحاً على ثنايا طيَّات شعره لشاعر مثل السيَّاب عاش مشاعر الغربة الخارجية في ارتحاله الاضطراري عن بلده, وتذوَّق مرارة الاغتراب النفسي الداخلي قبل يغادر وطنه, سواء أكان هروباً سياسياً أم علاجاً صحياً نتيجة مرضه الدامي. ومن نماذج ذلك الشعر ما قاله السيَّاب في قصيدته الشهيرة (وصيةُ مُحتضرٍ)التي يتمنَّى فيها على وطنه العراق الأثير أنْ يكون له فيه مجردُ قبرٍ صغيرٍ أو كوخٍ بسيطٌ يقضي فيه ما تبقَّى له من روحه العليلة وجسمه الناحل السقيم الذي أكله الضرُّ:
إِنْ مُتُّ يَا وَطَنِي فَقَبرٌ فِي مَقابِرِكَ الكَئِيبَةْ
أَقصَى مُنَايَ, وَإنْ سَلِمْتُ فَإنَّ كُوخَاً فِي الحُقُولِ
هُوَ مَا أُرِيدُ مِنْ الحياة فِدىً صَحَارَاكَ الرَّحِيبَةْ
والسيَّاب في جميع مراحل شعره الثلاث, المرحلة الأولى الغنائية الرومانسية الذاتية, ومرحلة الخروج الفكري عن الذاتية الفردية الضيقة إلى الذاتية الجمعية, والمرحلة الأخيرة, هي مرحلة الانفتاح على الواقع الاجتماعي عبر الواقعية الجديدة تمكَّن من خلال سعة ثقافته الموسوعية الكبيرة وانزياحه الفكري في تأسيس مشروعه الشعري الرائد الخاصّ بمعجمه السيَّابي الثرِّ. والذي توحّدت فيه فنياً وجمالياً سمات شعريته الفردية الخاصة بحياته مع سمات وخصائص شعريته الجمعية الموضوعية العامَّة. على الرغم من أنَّ كلَّ المعطيات النقدية لشعريته الحداثوية تؤكَّد مصيرياً بما لا يقبل الشكَّ من أنَّ بدر شاكر السيَّاب خُلِقَ في الوجود الكوني ليحيا شاعراً فذًاً كبيراً وشاخصاً شعرياً قائماً يُشار إليه ببنان الشعرية المتفرِّدة قبل أنّْ يكون إنساناً, وهو في الحقيقة الوجودية المكانية والزمانية لعصره الشاعر والإنسان معاً الذي لا يمكن أنْ نبخس هيبة ميزان شخصيته الثقافية المُبهرة.
جدليَّاً,ما الَّذي تَبقَّى من رَمزيَّةِ الَّسيَّابِ الشِّعريَّةٍ
رفعت شميس - تصميم مواقع الانترنت - سورية 0994997088
رفعت شميس - تصميم مواقع الانترنت - سورية 0994997088